السلفية الثقافية
سعيد السوقايلي
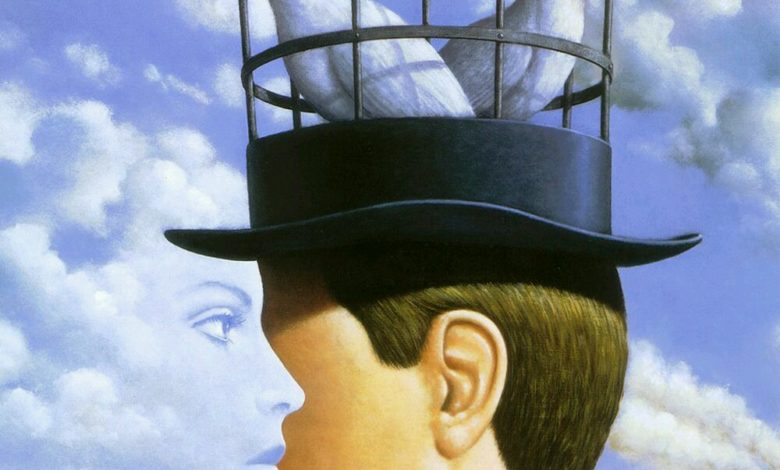
يبدو في كل نقاش حول مستقبل الثقافة في علاقتها بالتنمية أو بالسياسة بروز ثنائيات ضدية رمزية عدة، ذات منزع سياسي واجتماعي وديني وعرقي ولغوي… تتصارع في ما بينها تحت غطاء إيديولوجي معين، إذ كل جماعة أو فئة ثقافية تسعى لفرض هيمنتها الثقافية على الأخرى، عبر تنميط الوعي الشامل حول الحياة والفكر والأدب والفن وفق تصور وحيد للحقيقة يسود المجتمع، دون الإيمان بالتعددية الثقافية، فدائما، وحسب غرامشي، فهذه الهيمنة الواحدية تهدف إلى خدمة منظومة ثقافية أو نسق واحد لفئة معينة تريد تحقيق مصلحتها الخاصة.
لن نخوض طبعا في هكذا ثنائيات من قبيل: الشرق / الغرب، الرجل / المرأة، الأبيض/ الأسود، الرسمي/ الهامشي… أو تلك الخاصة بالاختلاف اللغوي أو العقدي…أو الصراع الثقافي بين جماعتين مختلفتين تباعد بينهما اللغة والجغرافيا بكل تلويناتها؛ بل سنركز على مفهوم الجماعة الثقافية الواحدة، ذات الطيف الواحد في جغرافية ضيقة تنحصر داخل وطن واحد، والتي تنزع دائما إلى رسم حدود ضيقة يُضرَب حولها خط أحمر كعتبة إيدولوجية فوقية تفرض هيمنتها السلفية (بمعناها الأبوي الأصولي) وذلك بتنميط كل كائن ثقافي داخل ثقافته الوطنية أو المحلية، وإلباسه قيما وسلوكات ورؤى من الوعي السائد سلفا، بمعزل عن أسلوب الحوار والإنصات، إذ حسب هذه الرؤية فكل نسق ثقافي يدعي الوحدة والتوحد يقتل الثقافة نفسها، ويجهض كل مشروع تنويري جديد يريد إنعاشها وتطويرها لمجابهة كل ثقافة أجنبية مضادة، ولنا في مقولة أوكتافيو باث خير مثال: (من عزلتها تموت الحضارة)، إن لم نقل معه أيضا كل (ثقافة) باعتبارها رافدا من روافد الحضارة.
فوفق هذا التصور، توجد داخل الثقافة الواحدة فئتان، فوقية وتحتية، ونركز على التحقيب الزمني والجيلي، ولكل منهما سلاحها الوجودي، ففي الوقت الذي تستمر فيه فئة النخبة بفرض سلطتها العليا ذات النزوع الأصولي والسلفي( ذريعة السبق دائما) والوصاية الأبوية المالكة لوسائل إنتاج ثقافي لا ينبغي له أن يفنى، على اعتبار أن تلك الوسائل والذرائع الرمزية هي معايير مطلقة يجب تبنيها على الدوام، وبشكل أعمى، مسخرة لذلك سلاح نزعتها الراديكالية بدعوى الأسبقية، ونضج الوعي، وتراكم الخبرات، وامتلاك المؤسسات الثقافية الرسمية بدءا من لوبية الحزب إلى أخر ذنب جمعوي للسلطة التي تعنكب في أركانها، هكذا هي دوما بهذا المن السادي لا تتورع في تقديم تصوراتها ومفاهيمها المعنوية والمادية، الأدبية والمالية؛ في الوقت الذي تسعى فيه الفئة الثانية الصاعدة، متدمرة ومتمردة، إلى تبني جبهة ثقافية مضادة، وفق الجدلية التي نبه إليها غرامشي، والقائلة بضرورة أن تنشئ الفئة الثقافية المهمشة لهيمنة بديلة، وذلك عبر اجتراح تصورات جديدة وأشكال مختلفة من التجارب والرؤى، من شأنها تثوير كل نمط ثقافي سائد، ولها في الوسائل المنفلتة من ربقة الرقابة طريق خلفية حتى توصل مشروعها.
نحن إذن أمام حلبة صراع تفرضها الظرفية التاريخية والتحولات الشاملة للحياة العامة، صراع إيديولوجي يطفو دائما كلما احتكت ثقافة القطب الواحد بأقطاب أجنبية، لتحدث هزات في الوعي المحلي السائد، حيث تنكشف ألوان ووسائل وقيم ورؤى ثقافية جديدة، هكذا تتخلخل كل منظومة ثقافية محليا ووطنيا إزاء كل جديد آت من خارجها، مما يولد هاجسا لدى أصولييها وسلفييها (الذين كانوا أكثر طليعية إزاء من سبقوهم) ينذر بخطر يهدد المصالح الخاصة والوصاية الاستقطابية لسدنة هذه الثقافة السلفية، ذلك أنهم يغالون في فعل الممانعة والتصدي والإقصاء ضدا على كل تجربة جديدة، فعل يغيب أيضا كل تواصل وانفتاح وإنصات بين الطرفين، ويشرخ بذلك فجوة ومسافة جمالية، دون إيمان بوعي ابستيمي، بين تينك البنيتين، الفوقية والتحتية، في تبادل صارخ للتهم، بين قتل الأب وعقوق الابن، وتلك مصيبة تؤجج العصيان الثقافي الذي سيفرز لا محالة ميليشيات ثقافية متعادية، بين مكفرين وبين مرتدين، صراع بين جبهة سلفية وأخرى طليعية نامية، تستعر فيها حرب ثقافية تُتبادل فيها لغة الإقصاء والتمرد، الوصاية ونزع الإعتراف، دون الجنوح إلى الاعتراف بالأخر، وتبادل الخبرات، والمصالحة الثقافية، وإذا كان هناك بد من الحرب، فلتكن حربا شريفة البراز، نصا بنص، ووعيا بوعي، وحساسية بحساسية، وإبداعا بإبداع… بإيمان واع، وحس ابستيمي، يعتبر مما راكمه السابق، وينصت للاحق بكل ما اجترحه من حساسية ثقافية جديدة، ونظرة وجودية مختلفة، وأعتقد أن كلا التصورين يصبان في مصلحة الثقافة الواحدة صيرورة وسيرورة.
إن هذا الصراع بين هاتين البنيتين الثقافيتين يخدم بشكل أو بأخر أجندة السياسي، حيث يحوز المثقفين الرسميين إلى حاشيته ومؤسساته، وبالتالي يمرر خطاباته الفوقية عبرهم إلى العامة، حتى بات هؤلاء المثقفون الرسميون بوقا يمجد السياسي، بل يسوقون الناس جميعا ويصيحون بهم بالولاء للدولة على حد تعبير الشاعر ويلفريد أوين؛ إن صورة المثقف السلفي هي صورة كربونية للسياسي، من حيث كون هذا الأخير لا يدرك أبدا أن أية إرادة للتغيير والتجديد والتنمية بغية خلق مشروع نهضوي لابد أن يصحبها وعي جدلي بالتغيرات البنيوية التي تحدث بين قاعدته وقمته، ثم من جهة أخرى لابد أيضا من ترسيخ نوع من المرونة مع المثقف المجدد لأدواته ورؤاه، وتلك هي آفة ساستنا الذين لم يعوا بعد أن قوة الدولة والأمة أيضا هي رهينة بقوة ثقافتها، وإلا فإن كل صراع يصطبغ بألوان الأنانية والمن أو التمرد داخل الثقافة الواحدة سيؤثر على سمعتها ويضعفها، ليجعلها دريئة سهلة أمام كل اجتياح ثقافي أخر يسلبها ويذيب هويتها ويطمس معالمها.
كاتب من المغرب